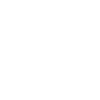المعتمد بن عباد في الأغلال
في حديقةِ قصرِهِ الغنَّاء أقامَ المعتضد ما يشبهُ المعرض الدَّائم لرؤوسِ قتلاهُ من القوَّاد والزُّعماء، وكانت عندَ رؤيتِها تملأ قلوبَ الناسِ ذعرًا، وقيلَ إنَّه كان في ليالي أُنسهِ يطلبُ رؤيةَ هذهِ الرُّؤوسِ، فتُحمَلُ إليهِ، فيداخلهُ السرورُ والبهجةُ بينما يتناولُ الخمرَ معَ ندمائه المَذعورين من رؤيتِها، وكانَ من بينِ هذهِ الرُّؤوسِ: رأسُ محمدٍ بنِ عبد الله البرزالي حاكمِ قرمونة، ورؤوسُ ابنِ خزرونَ حاكمِ شذونة واركش، وابنِ نوحٍ بنِ دمر حاكمِ مورور، ورأسُ يحيى بن علي بن حمود، ويقال إنَّه بالغَ في تطييبِ هذهِ الرُّؤوسِ وتنظيفها وأودعَها في أواني خاصَّة لحفظِها، وظلتْ إلى أن افتتحَ المُرابطون إشبيليةَ بقيادةِ سير بن أبي بكر، فوجدوها محفوظةً في أجولة وأواني. وهذا من غريبِ طِباعهِ التي تُعبِّرُ عن قسوتِهِ وجمودِ قلبِهِ، هواية جمع رؤوسِ القوّادِ والزُّعماءِ الذين انتصرَ عليهم وقتلهم في مَعاركِهِ، وظلتْ رؤوسُ القتلى تُحملُ إليهِ فيأمرُ بتحنيطِها وحفظِها، وعندما عثرَ المُرابطون على رأسِ يحيى بن علي بن حمود عند دخولِ قصرِ إشبيلية طلبتْ حفيدتُهُ "سُبيعة" أن تأخذَ رأسَ جدِّها لتدفنَهُ في المسجدِ الذي دُفن فيه عبد العزيز بن موسى بن نصير عندَ بابِ عنبر في إشبيلية. كان المعتضد بنُ عبَّاد– والدُ المعتمد -بالغَ القسوةِ حتى مع ذوي أرحامِهِ، وليسَ أبشع من إقدامهِ على قتلِ ابنهِ المنصور إسماعيل، بدمٍ بارد سنة 449هـ (1057م)، وكان المنصورُ في ذلك الوقتِ وليًّا للعهدِ وقائدًا للجيش، وقَتل معه وزيرَهُ المُقرَّب "البزلياني" الذي كان واحدًا من جهابذةِ الأدبِ في إشبيلية.
وردتْ وقائعُ تلكَ الحادثةِ البشعةِ عندَ المؤرِّخِ ابنِ حيان الذي كان معاصرًا لهذهِ الأحداث، وتفصيلُ المأساةِ أنَّ المعتضدَ كان يخطِّطُ في سنة 449هـ (1057م) لغزوِ مدينةِ الزَّاهرةِ، ضاحيةِ قرطبة الشهيرة، وكلَّفَ ابنَهُ وولي عهدِه المنصور إسماعيل لقيادةِ القوَّاتِ الغازية، ولكنَّه تباطَأ لأنَّه كانَ يرى أن مُهاجمةَ قرطبةَ طبقًا لهذهِ الخطةِ تنطوي على مخاطرةٍ لا يُحمدُ عُقباها، ولكنَّ المعتضدَ أغلظَ لهُ القولَ وألزمهُ أن يسيرَ بالحملةِ منذرًا إياهُ بالقتلِ إذا لم يمتثل؛ فدبَّرَ المنصورُ إسماعيل خطةً للهربٍ معَ بعضِ خواصِّهِ وشجَّعَهُ على ذلكَ وزيرُ أبيهِ وكاتبُهُ أبو عبد الله محمد بن أحمد البزلياني، وسهَّلَ له وسيلةَ الهروبِ إلى أطرافِ المملكة، منتهزًا فرصةَ استجمامِ أبيهِ في حُصنِ الزَّاهي على الضفَّةِ الثانيةِ لنهرِ الوادي الكبير، فجمعَ ما استطاعَ أخذَهُ من المَالِ والمتاعِ واصطحبَ أمَّهُ وحريمَه، وخرجَ من إشبيليةَ ليلًا ومعَه الوزير البزلياني وحرسٌ من ثلاثينَ فارسًا نحو مدينةِ الجزيرةِ الخضراء، ولكن جواسيسَ والدِهِ المعتضد أبلغوه على الفورِ فسارعَ إلى إرسالِ كتيبةٍ من فرسانه في أثرِ الهاربين، كما أنذرَ قوَّادَ القلاعِ والحُصونِ بعدمِ إيوائه، وكان إسماعيل وصحبُه قد لجؤوا إلى قلعةِ شذونة، واستقبلهُ قائدُ القلعةِ ابنُ أبي حصاد، وفي نفسِ الوقتِ عجَّل بإخطار المعتضد، فاستعادَهُ هو ومن معَه، وسجنَهُ في إحدى دورِهِ، وأعدَمَ الوزيرَ البزلياني وخواص إسماعيل، فأدرك إسماعيل مصيرَه المَحتومَ وأخذَ يدبِّرُ سرًّا معَ بعضِ مُعارضي أبيهِ لاقتحامِ القَصرِ وقتلِه، والجلوسِ مكانَه ملكًا على إشبيلية، وبالفعلِ اقتحمَ القصرَ ليلًا معَ بعضِ مؤيديه، ولكنَّه وقعَ في يدِ أبيهِ للمرَّةِ الثانية، فقتلَهُ على الفورِ بيدِه وأخفى جثَّتَهُ وأعدمَ عددًا من حريمهِ ونسائهِ ومُعاونيه، ولم يكنْ ذلكَ الحادثُ المأساوي هو الأول من نوعِهِ في تاريخِ الأندلس، فقد أقدمَ الخليفة عبد الرحمن الناصر على قتلِ ابنهِ عبد الله، والمنصور ابن أبي عامر على قتل ابنه عبد الله أيضًا في ظروفٍ مشابهة. وبلغَ من حيطتِه لملكهِ أن يُبيحَ لنفسِهِ الغدرَ، وخرقَ العهودِ، ومن ذلكَ ما ارتكبَهُ في حقِّ أبي زيد بن عبد العزيز البكري حاكمِ مدينةِ "ولبه" وجزيرةِ شلطيش، فقد عاهدَ أبو زيد المعتضدَ أن يتخلَّى له عن "ولبة" طواعيةً في مقابلِ أن يتركَ له جزيرةَ شلطيش، ووافقهُ المعتضدُ على ذلك، وعندما خرجَ البكري مبحرًا في سفنِهِ قاصدًا شلطيش حاملًا معَهُ أهلَهُ وأعوانَهُ ومالَهُ، هاجمَهُ المعتضدُ في وسطِ البحرِ وقطعَ عليهِ الطريقَ إلى الجزيرةِ ومنعَهُ من الوصولِ إليها، وأخذَهُ ومن معَهُ أسرى، ووضعَ الجزيرةَ تحتَ سلطانهِ، وعيَّنَ أحدَ قوَّادِه حاكمًا لها.
كانَ المعتضدُ بنُ عباد شغوفًا بتشييدِ القصورِ الفارهةِ وتجهيزها بأفخمِ المتاعِ بما يتماشى مع المظاهرِ الملوكيةِ التي كان يهواها حتى صار بلاطُهُ أعظمَ بلاطٍ بينَ ملوكِ الطوائف. وكانَ شغوفًا بامتلاكِ الإماءِ والجواري وأنجبَ عشرين من الذُّكورِ ومثلَهم من الإناث. وعلى الجانبِ الآخر من شخصيتِه التي كانتْ تثيرُ مشاعرَ الفزعِ كانَ أديبًا بارعًا وشاعرًا لا يُبارى، ينظمُ قصائدَ رائعةً، وترجعُ براعتُهُ في ذلكِ إلى ميراثٍ طبيعي؛ إذ كانَ ينحدرُ من أسرةٍ عربيَّةٍ ذاتِ مآثرَ عريقةٍ في الأدبِ والشعرِ، وكانَ المعتضدُ يقرِّبُ إليهِ الأدباءَ والشعراء، وكانَ من كبارِ شعراءِ الأندلس الذين أحبَّهم وقرَّبهم أبو الوليد بن زيدون الذي غمرَهُ بعطفهِ وثقتِهِ حتى أنَّه عيَّنه وزيرًا، وأصبحَ ذا مكانةٍ رفيعةٍ في بلاطِ إشبيلية. وقد وصلتْ إلينا أبياتٌ من الشعرِ نظمَها إثرَ أزمةٍ شديدةٍ حدثتْ بينَه وبينَ والدِهِ القاضي أبي القاسم بن محمد بن عبَّاد اضطرته إلى الرحيلِ من إشبيلية إلى أن استدعاه أبوه، وكانَ أبوه وقتَها حاكمًا لإشبيليةَ والمعتضدُ حاجبًا لها، وهي حافلةٌ بمشاعرِ الصدقِ والإخلاصِ لوالدهِ إلى جانبِ العتابِ المؤدَّبِ الذي يقتضيهِ واجبُ البنوَّة.
من هذه الأبيات الشعرية:
أطعتكَ في سري وجَهري جاهدًا فلم يكُ لي إلا الملامَ ثوابُ
فررتُ بنفسي أبتغي فَرجَةً لها على أنَّ حُلوَ العيشِ بعدكَ صابُ
وما هزَّني إلا رسولُكَ داعيًا فقلتُ أميرُ المؤمنينَ مُجابُ
ولكنَّكَ الدُّنيا إليَّ حبيبةٌ فما عنكَ لي إلا إليكَ
ذهابُ كان أبو القاسم بن عباد (ذو الوزارتين) والد المعتضد وجد المعتمدَ فقيهًا وقاضيًا شديدَ الثراء، ورثَ عن والدِهِ القضاءَ والثروةَ، يقال إنَّه حازَ ما يعادلُ ثلثَ أراضي إشبيلية، ولما ضاقَ الناسُ من تنافسِ الحموديين والأمويين على حكم المدينة، أغلقوا أبوابَها وطردوا حاكمَها، وولَّوا على أنفسهِم ثلاثةً من كبارِ قضاةِ إشبيلية، كان منهم أبو القاسم بن عباد ومع الوقت استبدَّ بالحكم، فأزاح زميليه وأصبحَ الحاكمَ الوحيدَ لإشبيلية، وعملَ عقبَ ذلك على توسيعِ مملكتِهِ وبسطِ نفوذِهِ. عيَّنَ القاضي أبو القاسم ابنَهُ المعتضد في منصبِ حاجبِ إشبيليةَ وكانَ مسرفًا باذخًا، ممَّا دعا والدَهُ إلى لومِهِ والتقتيرِ عليهِ حتى اضطرهُ إلى الرَّحيلِ عن المدينة، وكان المعتضدُ بإسرافِهِ وبذخهِ يعتقدُ أنَّهُ يستميلُ قلوبَ الناسِ إليهِ وفي هذا الموقفِ كتبَ المعتضدُ قصيدةً إلى والدهِ متماسكةَ البناءِ تفيضُ رقَّةً وعذوبةً تنُمُّ عن شاعرٍ موهوبٍ متمكنٍ، تكفينا منها الأبيات الآتية:
وفضلُكَ في تركِ الملامِ فأنَّهُ وحقكَ في قلبي ظبًا وحرابُ
إذا كانتْ النُّعمى تكدرُ بالأذى فما هي إلا محنةٌ وعذابُ
وبعد أن تُوفي والدُهُ القاسمُ بنُ عباد عام 433 هـ (1042م)، تولى المعتضدُ مقاليدَ الأمورِ وظلَّ يحكمُ مملكةَ إشبيليةَ ثمانية وعشرينَ سنةً قضى معظمَها في حروبٍ متوالية، إلى أن نالَ الإجهادُ الشديدُ من قدرتِهِ الصحيَّةِ وترتَّبَ على ذلكَ إصابته – كما ذكرَ المؤرِّخون – بما يشبهُ ذبحةً صدريةً قصيرةً أدتْ إلى وفاته، وكانَ ذلكَ في اليومِ الثاني من شهرِ جمادى الآخرة سنة 461هـ (1069م) وعمره يناهزُ الثلاثةَ وخمسينَ سنة. وفي نفسِ يومِ وفاةِ المعتضدِ خلفَهُ ابنُه محمدُ بن المعتضد بن عباد وحملَ لقبَ "المعتمد على الله"، وكان عندما تولَّى عرشَ مملكةِ إشبيليةَ الزاهرةِ في الثلاثينَ من عمرِه إذ كانَ مولده سنة 431هـ (1040م) في مدينةِ باجة. كان المعتمدُ بن عباد شابًّا يافعًا،جوادًا فاضلًا عفيفَ السيفِ، لم يكن مثلَ أبيهِ في القسوةِ والميلِ إلى سفكِ الدماء، أعادَ مَنْ نَفاهم أبوه وأبعدَهم عن ديارِهم، لا يأخذُ بأيِّ سعايةٍ ضدَ أحد، متزنًا في عدائِهِ وغضبهِ، ولكنَّهُ من ناحيةٍ أُخرى كان لا ينقطعُ عن مُعاقرةِ الخمرِ والانغماسِ في مَلذَّاتِ الحياة، محبًّا للخلودِ إلى الرَّاحةِ والاستجمام. لم يشتهرْ المعتمدُ في مجالِ الحربِ والسياسةِ مثلَ أبيهِ بقدرِ شهرتهِ في مَجالِ الشِّعرِ والأدبِ والفروسيَّةِ، وكانَ والدُهُ قد عيَّنَهُ واليًا على مدينةِ شلب بعدَ أن استولى عليها سنةَ 455هـ (1063م) واتَّخذَ وزيرًا لهُ أحدَ رجالِ أبيهِ وهو أبو بكر محمد بن عمَّار الفهري الذي سيكونُ دورُهُ محوريًا في حياةِ المعتمدِ إذ كلَّفَهُ بمهامَّ سياسيةٍ وعسكريةٍ خطيرة.
ولدَ ابنُ عمار في قريةٍ من ضواحي مدينةِ شلب تُسمى شنبوس– وهي الآن بلدةُ Estomar البرتغالية – سنة 422هـ (1031م)، وتعلَّمَ في مدارسِ شلب وأكملَ دراستَهُ في قرطبة، برعَ في فنونِ الأدبِ ونظمِ الشعر، وكان يتَّخذُهُ وسيلةً للتكسُّبِ بمدحِ ذوي المراكزِ والأكابر، مدحَ المعتضدَ في إشبيليةَ فأُعجبَ بهِ وضمَّهُ إلى شُعراءِ القصر، وتوثَّقتْ صلاتُ المودةِ والصَّداقةِ بينهما منذُ عيَّنَ المعتضدُ ابنَهُ المعتمدَ واليًا على مدينةِ شلب، فكلَّفَ ابنَ عمار بأن يكونَ وزيرَهُ المُقرَّب، وأصبحَ رفيقَ مجالسِ أُنسه، وسفيرَه إلى الملوكِ والأمراءِ، ورجُلَهُ الأمينَ الذي يعهدُ إليهِ بالمهامِ الصَّعبةِ فيؤدِّيها على أكملِ وجه، فزادتْ مكانتُهُ لدى المُعتمدِ وظلَّ يعملُ إلى جانبهِ كأنَّهُ الرَّجلُ الثاني بعدَه، إلى أن أخذتْ العلاقةُ بينَ المُعتمدِ وابن عمار تسوءُ وتفسدُ بتدبيرٍ من (اعتماد الرميكية) زوجُ المعتمدِ التي كانتْ أثيرةً لديهِ يهيمُ بها حبًّا، وتشتركُ في مجالسِ الشعرِ والأدبِ التي يعقدُها المعتمد، وتشاركه في توجيهِ شؤونِ الحُكم، وبسببِ مكانتِها العاليةِ أطلقَ عليها رجالُ القصرِ وأكابرُ المملكةِ لقبَ "السيدة الكبرى"، وكانتْ محظيَّةً عندَ المعتمدِ حتى أنَّهُ في أحدِ الأيامِ رأتْ اعتمادُ من شرفةِ قصرِها فتياتٍ يغسلنَ الملابسَ في الواد ويلعبنَ في الطين، فاشتهتْ أن تلعبَ مثلهن يغمرها الحنينُ إلى الماضي الذي كانتْ فيه جاريةً تغسلُ الملابسَ في النهرِ وتداعبُ رجليها في الطين، فلمَّا علمَ المعتمدُ بذلك، أمرَ بسحقِ كمياتٍ هائلةٍ من الطيبِ والمسكِ والكافورِ وماءِ الوردِ ونشرها على جنباتِ النهرِ حتى تشبَّعَ الطينُ برائحةِ الوردِ والمسكِ، فاصطحبَ اعتمادَ وجارياتِها للعبِ وسطه، ويُحكى أن اعتمادَ غضبتْ يومًا ما من المعتمدِ وأقسمتْ أنها لم ترَ منهُ خيرًا فأجابها: "حتى يوم الطين؟" فأحنتْ رأسَها واستحيت، ولا زالتْ هذهِ العبارةُ تتداولُ بينَ الناسِ للدَّلالةِ على نكرانِ الجميلِ، وأخذَ المعتمدُ يردِّدُ:
حبُّ اعتمادٍ في الجَوانحِ ساكنٌ لا القلبُ ضاقَ بهِ، ولا هو راحلُ
وكانت تنظرُ إلى ابن عمار بعينِ السخطِ والكراهيةِ بسببِ ازديادِ نفوذِهِ وقُربهِ من الملك، وكان ابن عمار يبادلُها المشاعرَ ذاتَها، وأمامَ نفوذِ الزوجةِ السَّاحرةِ كانَ من الطبيعي أن ينهزمَ ابنُ عمار، فتغيَّرتْ مشاعرُ المعتمدِ ناحيته، وتوتَّرتْ علاقتُهما إلى أن كتبَ ابن عمار أبياتًا من الشعرِ يهجو فيها الرميكية، فبلغتْ مسامعَ المعتمد، وكان من بينها:
تخيرتُها من بناتِ الهَجين رميكيَّةً ما تساوي عقالا
كما ساهمَ استيلاءُ ابنِ عمار غدرًا على مدينةِ مرسية في اشتدادِ العداءِ بينَهما، وكانتْ هذه الخيانةُ هي بدايةُ النهايةِ له، فبعدَ أن أُغلقتْ أبوابُ المَدينةِ في وجههِ فرَّ إلى بلاطِ الفونسو السادس، ثمَّ استقرَّ في سرقسطة عندَ حاكِمِها المقتدرِ بنِ هود -الذي تُوفي سنةَ 475هـ (1081م)، وقُسِّمَتْ أملاكُهُ بينَ أولادِه فكانتْ سرقسطة من نصيبِ ولدهِ المؤتمن وما لبثَ أن أغراهُ المؤتمنُ بنُ المقتدرِ أن يُغيرَ بقوَّاتِهِ على حصنِ شقورة، ولمَّا وصلَهُ أوهمَهُ قائدُ الحُصنِ ابنُ مبارك بأنَّهُ سوفَ يُسلِّمهُ إليهِِ دونَ حرب، وما كادَ يستقرُّ داخلَ الحُصنِ معَ رِجالِهِ حتى هجمَ عليهِ حرسُ ابنِ مبارك وقيَّدوهُ بالسَّلاسلِ وزجَّ بهِ إلى السجنِ وكانَ ذلكَ سنةَ 477هـ (1084م)، ثمَّ سلَّمَهُ مقابلَ مبلغٍ من المالِ إلى المعتمدِ بنِ عبَّاد.
وبشكلٍ مأساويٍّ جاءتْ نهايةُ أبي بكر بن عمار، وكان للوشاةِ أهمُّ دورٍ وكانتْ من خلف الوشاةِ تدفعُهم وتشجعُهم سرًا اعتمادُ الرميكية رغمَ أنَّه كانَ السببَ الرئيسي في زواجِ المعتمدِ بنِ عبَّاد منها عندما رآها لأوَّلِ مرَّةٍ برفقةِ مَولاها رُميك أحدِ وجهاءِ إشبيلية، حيثُ كان المعتمدُ يتنزَّهُ ذاتَ يومٍ في نهرِ الوادي الكبيرِ وبرفقتِهِ وزيرُهُ الأثيرُ أبو بكر بن عمار وألقى بيتًا شعريًّا لوصفِ الماءِ المتموّجِ "حاكت الرّيحُ من الماءِ زرد" وطلبَ من وزيرِهِ الشاعر أن يتممَ له البيتَ لكنَّه لم يستطع، فجأة سمعَ صوتًا نسائيًّا يقول "أي درعٍ لقتالٍ لو جَمد" فأُعجبَ المعتمدُ بفطنتِها وبحُسنِها وجمالِها ورقَّةِ قدِّها، فتولَّى ابنُ عمار إحضارَها إلى القصرِ وتزوَّجَها المعتمدُ وأنجبتْ له أولادَهُ الملوك، وعُرفتْ في التاريخِ باسمِ "اعتماد الرميكيَّة" منسوبةً إلى مَولاها "رُميك". اقتيدَ ابنُ عمار مُكبَّلًا بينَ يدي المعتمد، وتجمَّعَ آلافُ البشرِ من مُرسيَّةَ للتفرُّجِ على الوزيرِ الأوَّلِ وهو يمثُلُ في الأصفادِ خائفًا ذليلًا بعدَ أن كانتْ مواكبُهُ تسدُّ شوارعَ إشبيليةَ بحرسِهِ وحشمِهِ وخيولِهِ، وبعدَ أن وَبَّخَهُ المعتمدُ أمرَ أن يُودَعَ منفردًا في سجنِ القوَّادين واللصوص، وذكرَ المؤرِّخونَ أنَّ المعتمدَ استجابَ في النهايةِ لاستعطافِ ابنِ عمار له وبكائِهِ في حضرتِهِ ووعدَهُ بأنَّهُ سوفَ يصفحُ عنه، ولكنَّه سرعانَ ما نقمَ عليهِ بسببِ وشاياتِ الرَّاغبينَ في أملاكهِ فأطلعوا المعتمدَ على أبياتٍ من الشعرِ نظمَها ابنُ عمار في هجاءِ ابنِ عبادٍ وزوجتِهِ الأثيرةِ لديهِ اعتماد الرميكيَّة أثناءَ وجودِهِ في مُرسيةَ مشيرًا إلى أيامِ شبابهِ معَ المعتمدِ في شلب بإشاراتٍ بذيئةٍ بقوله:
سأكشفُ عرضَكَ شيئًا فشيئا وأهتكُ ستركَ حالًا فحالا
وكانَ رأسُ الوشايةِ عندَ المعتمدِ ضدَ ابنِ عمار عدوهُ اللَّدودُ أبو بكر بن زيدون، والدُ الشاعرِ الشهيرِ الوزيرِ ابنِ زيدون، بعد أن أحسُّوا أنَّ المعتمدَ يتَّجهُ إلى أن يصفحَ عنهُ، وكانَ أبو بكر بن عبد العزيز حاكمُ بلنسية الذي سرَّبَ أبياتَ شعرِ الهجاءِ مكتوبةً بخطِ ابنِ عمار، ما جعلَ المعتمدُ يضطرمُ سخطًا ضدَ ابنِ عمار، فطلبَ من فورهِ إحضارَهُ من محبسِه، ورغمَ أنَّ ابنَ عمارٍ نظمَ قصائدَ استعطافٍ أرسلها إلى المعتمد تذيبُ القلوبَ، وردَ منها:
سَجاياكَ إن عافيت أندى وأسمح وعذرُكَ إن عاقبتَ أجلى وأوضح
حنانيكَ في أخذي برأيكَ لا تُطع عداي ولو أثنوا عليكَ وأفصحوا
ولا تلتفتْ قول الوشاةِ وزورهم كلُّ إناءٍ بالذي فيهِ يرشح
ورغمَ بكاءِ أبي بكر بن عمار واستعطافهِ عندَما رأى المعتمدَ يحملُ في يدهِ بلطةً (طَبَرْزِين) سارعَ المعتمدُ بضربهِ في رأسهِ عدةَ مرَّاتٍ حتى قتلهُ، وأمرَ أن يُدفنَ في أطرافِ القصرِ المباركِ، وكانَ مقتلُهُ في أواخرِ سنةِ 477هـ (1085م).
وقال المعتمدُ بعدَ ذلكَ إنَّهُ ندمَ ندمًا عظيمًا على تسرُّعِهِ في قتلِ هذا الشاعرِ العظيمِ والسياسي البارعِ الذي كان يُعدُّ من أعظمِ رجالِ السياسةِ والأدبِ في عصرِ ملوكِ الطَّوائف. كانت الأيامُ تمضي والصراعاتُ تشتدُّ، وما إن استقرَّ يوسفُ بنُ تاشفين في المغربِ حتى عادَ ملوكُ الطوائفِ إلى التناحرِ من جديد، ولم يغيرْهُم انتصارُهُم في موقعةِ الزَّلَّاقَة بقيادةِ ابنِ تاشفين، وفي نفسِ الوقتِ لم تتوقفْ غاراتُ نَصارى الشَّمالِ على مدنِ الأندلسِ الشَّرقيةِ التي سَادَها الاضطرابُ والفَوضى، ممَّا جعلَ أهلَ المدنِ يستغيثونَ بالأميرِ يوسفَ بنِ تاشفين، ويرسلونَ وفودَهم إليهِ يطلبونَ منهُ النجدة.
وهُرِعَ المعتمدُ بنُ عباد نفسُهُ عابرًا المَضيقَ ليطلبَ من ابنِ تاشفين إنقاذِ مدنِ شرقِ الأندلسِ من غَاراتِ النَّصارى المدمرةِ، وجاءَ ابنُ تاشفين على رأسِ جيوشِهِ الجرَّارةِ وحاصرَ حصنَ لييط مع قواتِ ملوكِ الطوائفِ، وعلى رأسِهم المعتمدُ بن عباد، ولكنَّهم فشلوا في اقتحامِهِ لشدَّةِ تحصينِهِ من ناحيةٍ، ولنشوءِ الخلافِ بينَ ملوكِ الطوائفِ وعدمِ جديتهم في القتالِ من ناحيةٍ أُخرى، ممَّا أثارَ حفيظةَ ابنِ تاشفين عليهم، وتغيَّرتْ نفسُهُ حيالَهم. غادرَ ابنُ تاشفين الأندلسَ حزينًا آسفًا من حالِ ملوكِ الطوائفِ الذي كان ينذرُ بضياعِ دولةِ المسلمينَ في الأندلس، وعبرَ البحرَ عائدًا إلى المغربِ بعدَ أن تركَ حوالي أربعةِ آلافٍ من فرسانِهِ تحتَ قيادةِ واحدٍ من كبارِ قوَّادِهِ، وهو داودُ بنُ عائشة، وكانَ هذا التصرُّفُ يعكسُ الموقفَ الجديدَ لـيوسفَ بنِ تاشفين وهو قرارُهُ الخطيرُ بالاستيلاءِ على كلِّ دويلاتِ الطوائفِ في الأندلس.
لم يمكثْ يوسفُ بنُ تاشفين كثيرًا في حاضرةِ ملكهِ بالمغربِ إذ إنَّهُ في أوائلِ سنةِ 483هـ (1090م) قادَ حملةً عسكريةً وعبرَ إلى الأندلس، وكانَ المعتمدُ بنُ عباد قد عملَ على توثيقِ صلاتِهِ بالملكِ الفونسو السادسِ، وأغدقَ عليهِ بالهدايا النفيسةِ من مالٍ وثيابٍ وتحفٍ، فوعدَهُ الملكُ بنصرتِهِ ضدَ عدوِّهم المشتركِ يوسفَ بنِ تاشفين. ذكرَ المؤرخونَ العربُ أنَّ العلاقاتِ التي كانتْ في أوَّلِ الأمرِ علاقاتُ صداقةٍ وتحالفٍ بينَ يوسفَ بنِ تاشفين والمعتمدِ بنِ عبَّاد تحولَّتْ إلى كراهيةٍ شديدةٍ متبادلةٍ بينَ الاثنينِ لخوفِ المعتمدِ من استيلاءِ يوسفَ على مملكتِهِ الزاهرةِ إشبيلية، وحَنِقَ وغَضبَ يوسفُ من المعتمدِ لتحالفِهِ السِّري معَ الفونسو ملكِ قشتالةَ، ويطلبُ منهُ معاونتَهُ ضدَّهُ وبعثَ يوسفُ إلى ابنِ عبَّادٍ برسُلِهِ يطلبُ منه عدمَ مصانعةِ النَّصارى والاحتماءِ بهم، كما طلبَ منهُ أن يمتنعَ عن مُجاهرتِهِ بالمعاصي، والمبالغةِ في فرضِ الضَّرائبِ على شعبهِ، وأن يحكمَ بما يتَّفقُ معَ الشَّرعِ الإسلامي، ولكنَّ ابنَ عباد لم يمتثلْ بل بالغَ في الاندفاعِ نحوَ قشتالةَ لكي تحميهِ من خطرِ المُرابطينَ الدَّاهم. وعندما غادرَ ابنُ تاشفين عائدًا إلى المغربِ فوَّضَ أعظمَ قوَّادِهِ سير بن أبي بكر بقيادةِ جيوشِهِ المتمركزةِ في الأقاليمِ التي استولى عليها، وإدارة شؤونها، وأمرهُ بمجرَّدِ أن يبعثَ إليهِ بالمددِ من المغربِ أن يبادرَ إلى حصارِ مدينةِ إشبيلية. شعرَ المعتمدُ بنُ عباد أنَّ الدَّورَ قادمٌ على مملكةِ إشبيليةَ لا محالة، فأخذَ يتأهَّبُ معَ قوَّادهِ للدفاعِ عنها ضدَ يوسفَ بنِ تاشفين، فأقامَ التحصيناتِ وبنى حولَها أسوارًا دفاعيةً عاليةً منيعة.
كان ابنُ تاشفين يعلمُ جيدًا مدى قوةِ جيوشِ إشبيليةَ وتحصيناتِ قواعدِها المنيعةِ التي أعدَّها المعتمدُ بنُ عباد منذُ أن ساءتْ العلاقاتُ بينَهما، وتوجَّسَ ابنُ عباد من سوءِ نَوايا ابنِ تاشفين نحوَ مملكتِه. شرعَ القائدُ المُرابطي سير بن أبي بكر في تنفيذِ خططِ ابنِ تاشفين في الاستيلاءِ على قواعدِ إشبيليةَ الحصينة، وزحفَ نحوَ حصونِ إشبيليةَ وحاصرَها بينَما المعتمدُ بنُ عباد يتحصَّنُ بداخلِها، واستمرَ حصارُ قوَّاتِ المرابطينَ له عدَّةَ أشهر.
وبعثَ المعتمدُ بنُ عباد إلى الفونسو السادسِ يطلبُ مساعدتَه، وكانَ ملكُ قشتالةَ قد أصابَهُ الفزعُ من اجتياحِ المُرابطينَ لإشبيليةَ الذين أصبحَ خطرُهم يتهدَّدهُ هو نفسه، فسارعَ بدفعِ حملةٍ عسكريةٍ بقيادةِ أكبر قوَّادهِ البار هانليس لصدِّ المُرابطين والتقى الجيشانِ في معركةٍ في ضواحي إشبيليةَ انتصرَ فيها المُرابطون، ومع ذلكَ ظلَّتْ إشبيليةُ صامدةً، تدافعُ المرابطين ببسالةٍ، إلى أن تمكَّنتْ فرقةٌ من المُرابطين من اقتحامِ المدينةِ، بمساعدةِ بعضِ مُعارضي المعتمدِ بداخلِها، من أحدِ أبوابها وهو "باب الفرج" في الثاني والعشرين من رجب 484هـ (سبتمبر 1091م) وأحرقَ المرابطونَ سُفنَ أسطولِ إشبيليةَ الكبيرِ الذي كان راسيًا في نهرِ الوادي الكبيرِ واقتحموا قصرَ المعتمد.
فوجئَ المعتمدُ بنُ عباد بالمرابطين داخلَ أسوارِهِ فبادرَ على رأسِ فرسانهِ يصدُّ المعتدينَ في معركةٍ رهيبةٍ أصيبَ المعتمدُ فيها بطعنةٍ، لكنَّهُ تمكَّنَ من طردِ المهاجمينَ خارجَ الأسوار. إلا أنَّ حرقَ أسطولِهِ أصابَ دفاعاتِهِ بالانهيار، وفرَّ الكثيرُ من جُندهِ وسيطرتْ الفوضى على المدينةِ وأهلِها، فشدَّدَ المرابطونَ الهجومَ واقتحموا المدينةَ بأعدادٍ هائلةٍ، امتلأتْ بهم شوارعُها، ووصلوا إلى قصرِ المعتمدِ الذي دافعَ معَ فرسانهِ ببسالةٍ نادرةٍ، ولكنَّ المُرابطين استولوا تمامًا على إشبيليةَ وعلى القصرِ الملكي، فوقعَ المعتمدُ بنُ عبَّاد في أسرِ المُرابطين، وأتوا بابنهِ "مالك" المُلقَّبِ بـ "فخرِ الدولة" وقتلوه أمامَه، ونهبوا قصورَهُ كلَّها وعاثوا في المدينة قتلًا وتدميرًا، وبعدَ أن أتى المعتمدُ بنُ عبادٍ مكبَّلًا في الأغلالِ أمامَ القائدِ "سير بن أبي بكر" أذلَّهُ قبلَ أن يمنحهُ الأمانَ في نفسِهِ وأهله، وطلبَ منهُ أن يُرغمَ ابنَهُ "يزيد الراضي" حاكمَ "رندة"، وابنَهُ الثاني "أبا بكر المعتد بالله" حاكمَ "مرتلة" – الموجودة حاليًّا جنوبَ البرتغال – أن يسارعا إلى تسليمِ المدينتينِ إليهِ دونَ قتال، ولم يكن "سير" قد تمكَّن من احتلالهما لشدةِ تحصينِهما، وتمَّ له ما طلبَ وأذعنَ الإثنان، فسلَّمَ يزيدُ الراضي مدينةَ "رندة" إلى القائدِ جرور المرابطي الذي بادرَ إلى إعدامِ يزيدَ ونهبِ أموالِه، وسلَّمَ أبو بكر "مارتله" ثم نُفيَ إلى المغرب، وبذلكَ احتلَّ المُرابطونَ جميعَ قواعدِ إشبيليةَ وحصونها، وسقطتْ مملكةُ إشبيليةَ إلى الأبد.
سقطتْ إشبيليةَ سقوطًا دمويًّا، وذاقَ المعتمدُ بنُ عباد العظيمُ وأولادُهُ ونساؤهُ وسائرُ أهلِه هوانَ الأسرِ في قبضةِ المرابطينَ، الذي ساهمَ هو بشكلٍ فعالٍ في استدعائهم إلى الأندلس، وأصبحت إشبيليةُ منذ عام 1091م ولايةً مرابطية. وانتهتْ أسرةُ بني عبَّادٍ بعدَ أن لعبتْ دورًا بارزًا في الحياةِ السياسيَّةِ والأدبيَّةِ والشعريَّةِ ليسَ في إشبيليةَ وحدِها، بل في ربوعِ الأندلسِ كلِّها، ومنَ المؤكَّدِ أنَّ التقاليدَ والثقافةَ العلميةَ التي توارثتها هذهِ الأسرةُ ذاتُ الأصولِ العربيةِ العريقةِ ساعدتها على أن يكونَ للأدبِ وفنِّ الشعرِ لدى أجيالِها المتعاقبةِ أهميةً قُصوى جعلت شهرة شعراءِ بني عبَّاد تتجاوزُ حدودَ الأندلسِ لتنطلقَ إلى المغربِ كلِّهِ وإلى المشرقِ العربي.
كانتْ محنةُ المعتمدِ بنِ عبادٍ بعدَ سقوطِ إشبيليةَ ووقوعِهِ في الأسرِ قاسيةً ومأساويَّةً إلى حدٍّ كبير، فقد بالغَ يوسفُ بنُ تاشفين في خصومتهِ وعداوتهِ للمعتمد، فلم يكتفِ بوضعِهِ في الأغلال، بل عمدَ إلى قتلِ أربعةٍ من أبنائهِ، وهم: الفتحُ المأمون في قرطبة، ويزيدُ الراضي في راندة، وأبو بكر المعتد بالله في مارتلة، ومالك الذي قُتلَ أثناءَ اقتحامِ قصرِ إشبيلية، وأبقى بن تاشفين على حياةِ المعتمد إمعانًا في التنكيلِ بهِ وإذلالِهِ، وكانَ يراهُ حليفَ النَّصارى الحميم، وأمرَ ابنُ تاشفين أن يُنفى المعتمدُ إلى المغربِ مُكبَّلًا في أغلالهِ ومعَهُ زوجتُهُ اعتمادُ الرميكيَّة وما تبقَّى من أولادِهِ وبناتِه، فنُقلوا بالسُّفنِ إلى طنجةَ، ثمَّ حُملوا إلى مكناسةَ، لينتقلوا من عزِّ القصورِ إلى ذُلِّ السُّجون. وأمرَ ابنُ تاشفين أن يكونَ مقرَّ الملكِ الأسيرِ المعتمدِ وأسرتِهِ في مدينةِ "أغمات" وهي قريةٌ حصينةٌ موجودةٌ حتى الآنَ جنوبِ شرقِ مدينةِ مراكش. وأُنزلَ الملكُ الأسيرُ وأسرتُهُ في قلعةٍ شديدةِ التحصينِ واستقرُّوا في سجنِها الرَّهيب، وكانَ ابنُ تاشفين يضيّقُ عليهم أشدَّ الضيقِ ولم تصلنا أخبارٌ عن بناتِهِ سوى "بثينة بنت المعتمد"، التي كانت من شاعراتِ الأندلسِ في عصرِ بني عبَّاد، من زوجتهِ اعتماد، وكانت مثلَها في الجمالِ ونظمِ الشعر. ولمَّا سقطتْ إشبيليةُ كانت بثينةُ من سبايا المرابطين، واشتراها أحدُ التجارِ وأرادَ أن يُعاشرَها على أنَّها محظيَّة، ولكنَّها أبت وعرَّفتهُ بأصلِها، وطلبت إليهِ أن يتزوَّجَها، وكتبتْ إلى والديها السجينين في أغمات قصيدةً مشهورةً من الشعرِ تطلبُ منهما أن يوافقا على زواجها من هذا التاجر، فأدخلتْ عليهما سعادةً كانتْ مفقودةً لما عرفا أنَّها على قيد الحياة، ومرَّتْ سنواتٌ من الأسرِ في أغمات، ولم تتحمَّل اعتمادُ الرميكيَّة وطأةَ جدبِ الحياةِ، فماتت ودُفنت بالقرب من القلعةِ المعتقلِ فيها زوجها وأولادها، وحملت لنا كتبُ الأدبِ العربي قصائدَ رائعةً نظمَها المعتمدُ بنُ عباد يرثو فيها حالَهُ ومحنتَهُ وهو في سجنه، اخترنا منها أبياتًا من قصيدةٍ كتبها صباحَ يومِ العيدِ وهو يرى بناتِهِ جائعاتٍ حافياتٍ كسيرات:
فيما مَضى كُنتَ بالأعيادِ مَسرورا وكان عيدكَ باللذاتِ مَعمورا
وكنتَ تحسبُ أن العيدَ مسعدةٌ فساءكَ العيدُ في أغمات مَأسورا
ترى بناتكَ في الأطمارِ جائعةً في لبسهنَّ رأيتَ الفقرَ مَسطورا
قد أُغمضت بعد أن كانت مفتّرةً أبصارهنَّ حسيراتٍ مكاسيرا
يطأن في الطينِ والأقدام حافيةً تشكو فراقَ حذاءٍ كانَ موفورا
قد كانَ دهركَ إن تأمره ممتثلاً لما أمرت وكان الفعلُ مبرورا
وكم حكمتَ على الأقوامِ في صلفٍ فردّك الدهرُ منهيًا ومأمورا
من بات بعدك في ملكٍ يسر به أو باتَ يهنأُ باللذاتِ مسرورا
ولم تعظهُ عوادي الدهرِ إذ وقعت فإنما باتَ في الأحلامِ مغرورا
وفي شوال 488هـ (1095م) تُوفي المعتمدُ بنُ عباد وعمرُه 57 سنةً، ودُفنَ في مقبرةٍ إلى جانبِ زوجتِهِ اعتماد، وبعدَ زوالِ دولةِ المرابطينَ تحوَّلَ قبرُ المعتمدِ بنِ عباد إلى مزارٍ يقصدهُ محبُّوه، فيما تطلُّ الحكايةُ برأسِها من خلفِ الزَّمنِ تلقي إلينا بالدروسِ والعِبر، ورغمَ أنَّ التاريخَ هو المعلِّمُ الأكبر إلا أنَّ الحقيقةَ الصَّادمةَ هي أنَّهُ: لم يتعلَّم أحدٌ شيئًا.
محمود يوسف خضر
كاتب فلسطيني يُقيم في أبوظبي

نص كمثال